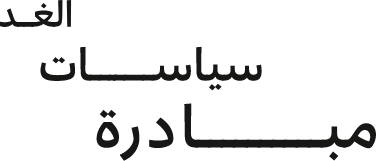- eng
-
- share
-
subscribe to our mailing listBy subscribing to our mailing list you will be kept in the know of all our projects, activities and resourcesThank you for subscribing to our mailing list.
ما بعد الزراعة: كشف النقاب عن وجوه الاستيلاء على الأراضي في العالم العربيٍّ

في عام 2018، استيقظت جماعة ساحليّة في جنوب لبنان لتجد مراعيها محاطةً بالأسوار، بعدما أُعيد تصنيفها، بين ليلة وضحاها، كمنطقة لإعادة التحريج في إطار مبادرة بيئيّة جديدة. وبالرغم من الترويج لهذا المشروع بوصفه إنجازًا بيئيًّا، فقد أدّى عمليًّا إلى تهجير عشرات العائلات، وقطع صلتها بالأرض التي اعتمدت عليها لأجيال، من دون أيّ استشارة أو تعويض. وقد برز نمط مشابه في أوائل تسعينيّات القرن الماضي في الأردنّ، حين أُنشئت محميّة ضانا للمحيط الحيويّ، فمُنع الرعي والصيد، ما عطّل سبل عيش جماعات بدويّة شبه متنقّلة في محيط قرية ضانا. وقد خسر العديد من السكّان حقّ الوصول إلى الأراضي التي استخدموها لأجيال، واضطرّوا إلى التحوّل نحو العمل الحكوميّ أو المصانع لتأمين معيشتهم.
تُظهر هذه الحالات توجّهًا أوسع يسود العالم العربيّ: فالأراضي تُنتَزع بشكل متزايد – سواء بوسائل قانونيّة أو بطرائق أخرى – لأغراض تتراوح بين البنى التحتيّة والسياحة وحماية البيئة والأمن القوميّ. وغالبًا ما تُقدَّم هذه المبادرات بلغة التقدّم أو الاستدامة، غير أنّها تنتهي في كثير من الأحيان إلى تجريد الجماعات الهشّة من أراضيها، كاشفةً أنّ الاستيلاء على الأراضي يتجاوز بكثير ما هو معروف من حالات الاستحواذ الزراعيّ واسع النطاق.
يوسّع هذا المقال فهم ظاهرة الاستيلاء على الأراضي في المنطقة العربيّة، من خلال الكشف عن الأساليب المتنوّعة – وأحيانًا المفاجئة – التي يُستَحوَذ بها على الأراضي، سواء من قِبَل المؤسّسات الحكوميّة أو الجهات الفاعلة الخاصّة، وغالبًا تحت عناوين تبدو تقدّميّة على السطح. وانطلاقًا من مراجعة منهجيّة للأدبيّات، يقدّم المقال تصنيفًا للاستيلاء على الأراضي استنادًا إلى ثلاثة محاور متداخلة: وجود الموارد الطبيعيّة، وحجم الاستيلاء، وتمييز ما يُسمّى «الاستيلاءات الخضراء» من «الاستيلاءات غير الخضراء». ومن خلال هذا الإطار، يبرز المقال الطبيعة المتعدّدة الأوجه لظاهرة الاستيلاء على الأراضي في العالم العربيّ، والحاجة إلى مقاربتها بمختلف وجوه تعقيداتها.
ينبع الدافع الأوّل والرئيس وراء الاستيلاء على الأراضي في المنطقة من القيمة الاقتصاديّة للموارد الطبيعيّة. فقد أصبحت البلدان الغنيّة بالنفط أو الغاز أو المعادن بؤرًا ساخنة لعمليّات استيلاء مرتبطة بالصناعات الاستخراجيّة. ففي العراق، على سبيل المثال، تُمنَح امتيازات واسعة النطاق للتنقيب عن النفط وإنشاء البنى التحتيّة، فيما تلتهم مشاريع تعدين الفوسفات في الأردنّ مساحات شاسعة من الأراضي. وبالرغم من إسهام هذه العمليّات إسهامًا ملحوظًا في الاقتصادات الوطنيّة، فإنّها غالبًا ما تخلّف أضرارًا بيئيّة لا رجعة فيها، وتؤدّي إلى تهجير السكّان المحلّيّين. يمثّل التلوّث وتدمير المواطن الطبيعيّة والمشكلات الصحّيّة نتائج شائعة، فيما تجد المجتمعات التي عاشت طويلًا في انسجام مع بيئتها نفسها مهمَّشة أو مُجبَرة على الرحيل. وفي مثل هذه الحالات، لا يُستولى على الأراضي لأغراض زراعيّة أو بيئيّة فحسب، بل بسبب ما تختزنه من ثروات تحت سطحها.
كما يختلف الاستيلاء على الأراضي اختلافًا واسعًا من حيث حجمه. فبينما ركّزت الدراسات المبكرة في هذا المجال، والمنصّات الأساسيّة التي ترصد عمليّات الاستحواذ على الأراضي، مثل قاعدة بيانات Land Matrix، على الصفقات الضخمة التي تعقدها الشركات الأجنبيّة، فإنّ الأراضي تُنتزع بالقدر نفسه على مستوى المجتمعات المحلّيّة، على أيدي نخب وطنيّة أو محلِّيّة نافذة. وغالبًا ما تكون هذه الاستحواذات الصغيرة الحجم أقلّ وضوحًا وأكثر صعوبةً في الرصد، لكنّها ليست أقلّ ضررًا، لا سيّما في المناطق الريفيّة حيث تقوم أنظمة حيازة الأراضي على الحقوق العُرفيّة أو غير الرسميّة. وفي الطرف الآخر من الطيف، تنخرط الحكومات الوطنيّة والشركات متعدّدة الجنسيّات في صفقات عابرة للحدود تشمل آلاف الهكتارات. وغالبًا ما تُضفى على هذه الصفقات صبغة قانونيّة وتُسوَّغ علنًا بذريعة خدمة التنمية أو تحقيق أهداف إستراتيجيّة، غير أنّ نتائجها تكون في الغالب كارثيّة على السكّان المحلّيّين الذين يفقدون منازلهم، وسبل عيشهم، وصلتهم بالأرض الموروثة عن أجدادهم.
تمثّل عمليّات التوسّع العمرانيّ والصناعيّ بُعدًا أساسيًّا آخر من أبعاد الاستيلاء على الأراضي غير الزراعيّة. فمع سعي الحكومات العربيّة إلى تنفيذ برامج طموحة لتنويع الاقتصاد، تستثمر بكثافة في بناء مدن جديدة، ومراكز سياحيّة فاخر، ومناطق صناعيّة. وتتصدّر دول الخليج، مثل الإمارات العربيّة المتّحدة وقطر، هذا المجال، إذ تُشيَّد مشاريع عمرانيّة مستقبليّة تتطلّب مساحات شاسعة من الأراضي، أحيانًا من طريق استصلاح الأراضي أو تحويل مجتمعات ساحليّة تقليديّة. وبالرغم من أنّ هذه المشاريع قد تخلق فرص عمل وتحسّن البنى التحتيّة، فهي تمحو في الوقت نفسه تواريخ محلّيّة وتقتلع أنماط حياة متجذّرة منذ زمن بعيد. وتتجلّى أنماط مشابهة في المناطق الصناعيّة التي تستبدل بالأراضي الزراعيّة ومجتمعاتها الريفيّة مصانعَ ومراكزَ خدمات لوجستيّة. كما يزيد من حدّة المشكلة تطوير البنى التحتيّة، بما في ذلك الطرق السريعة، والسكك الحديديّة، والمرافئ، والقواعد العسكريّة. فعلى الرغم من حيويّة هذه المشاريع للتجارة والأمن القوميّ، فإنّها غالبًا ما تُنفَّذ عبر الاستملاك الإجباريّ للأراضي من من دون تعويض كافٍ أو استشارة جدّيّة، ممّا يتسبّب في النزوح والتدهور البيئيّ.
وفي المناطق المتأثّرة بالنزاعات، تتّخذ عمليّات الاستيلاء على الأراضي أشكالًا أشدّ إثارةً للقلق. ففي بلدان مثل سوريا واليمن وفلسطين، تتحوّل الأرض إلى أداة حرب وسيطرة، إذ تستولي الجماعات المسلّحة والميليشيات، وكذلك بعض الفاعلين الرسميّين، على الأراضي، لا بغرض التنمية، إنّما لفرض الهيمنة أو تغيير البُنى الديموغرافيّة. وتحدث هذه الممارسات خارج أيّ إطار قانونيّ، وغالبًا ما تترافق مع العنف والتشريد القسريّ والتدمير المتعمَّد للممتلكات. وفي مثل هذه الحالات، لا يقتصر الاستيلاء على الأراضي في مسألة المساحة الجغرافيّة، بل يتعلّق بموازين القوّة ذاتها، تاركًا جراحًا يمكن أن تمتدّ آثارها عبر أجيال متعاقبة.
يُعَدّ أحد أكثر أشكال الاستيلاء على الأراضي مفارقةً ذاك الذي يتمّ تحت ستار الاستدامة البيئيّة. ويُعرَف هذا النوع باسم «الاستيلاء الأخضر»، إذ يشمل انتزاع الأراضي لأغراض الحماية البيئيّة، أو إعادة التحريج، أو مشاريع الطاقة المتجدّدة. وعلى الرغم من تسويق هذه المبادرات بوصفها صديقة للبيئة وضروريّة لمواجهة تغيّر المناخ، فإنّها قد تخلّف عواقب بالغة الوطأة على المجتمعات التي تعيش على تلك الأراضي أو تعتمد عليها. ففي لبنان، على سبيل المثال، أدّى العمل على حماية غابات الأرز إلى تقييد وصول الرعاة إلى مناطق الرعي الحيويّة، من دون تأمين أراضٍ بديلة أو إشراكهم في عمليّات صنع القرار. وفي الأردنّ، أدّى إنشاء المحميّات الطبيعيّة إلى تهجير المزارعين والرعاة، وقطع صلتهم بأراضٍ كانت مصدر رزقهم لأجيال. تتطلّب مزارع الطاقة الشمسيّة والهوائيّة واسعة النطاق، التي تنتشر بشكل متزايد في مختلف أنحاء المنطقة، مساحاتٍ شاسعة غالبًا ما تتداخل مع مسارات الرعي التقليديّة أو مع أنظمة بيئيّة هشّة. صحيحٌ أنّ هذه الأراضي قد تبدو خالية أو غير مستثمَرة، إلّا أنّها تظلّ ضروريّة لسبل العيش المحلّيّة وللتوازن البيئيّ. وعندما يُستولى على الأراضي باسم «البيئة الخضراء» من دون استشارة أو تخطيط ملائمَين، تكون النتائج مدمِّرة وغير عادلة تمامًا مثل أيّ استيلاء صناعيّ أو استخراجيّ على الأراضي.
إنّ فهم التصنيفات المتنوّعة لظاهرة الاستيلاء على الأراضي في العالم العربيّ – من عمليّات الاستحواذ المدفوعة بالموارد الطبيعيّة إلى تلك المُسوَّغة بسرديّات التنمية أو البيئة – يُعَدّ أمرًا أساسيًّا لابتكار مسارات أكثر عدلًا واستدامة. وغالبًا ما تتداخل هذه الأشكال، ما يجعل رصدها ومعالجتها أكثر صعوبة. فقد ينطوي مشروع بيئيّ على تطوير للبنى التحتيّة، أو يُقام على أرض جرى الاستيلاء عليها قبل عقود عبر الإكراه السياسيّ. ويكشف هذا الترابط تعقيدَ سياسات الأرض في المنطقة، ويستدعي إجراء مقاربات أكثر دقّة وعمقًا. إنّ التصدّي لظاهرة الاستيلاء على الأراضي يقتضي الاعتراف بأنّ الأرض ليست مجرّد سلعة، بل هي مصدر للهويّة والثقافة والبقاء والانتماء. ومن ثمّ، ينبغي لأيّ مشروع تنمويّ – مهما حَسُنت نيّاته – أن يضع في صدارة أولويّاته حقوق المتأثّرين به وأصواتهم. كما يتعيّن على الحكومات والجهات الدوليّة أن تضمن الشفافيّة، وتفرض الضمانات، وتلتزم بمبدأ الموافقة الحرّة والمسبقة والمستنيرة. ولن يكون بالإمكان تطبيق سياسات تحمي الإنسان وتُعزّز التنمية الشاملة فعلًا إلّا من خلال الاعتراف بمختلف الأشكال التي يُستولى بها على الأراضي، سواء باسم النموّ أو الاستدامة أو الاستقرار.
هذه المقالة جزءٌ من مشروع بحثيّ تعاوني بعنوان «المناخ والأرض والحقّ: السعي للعدالة الاجتماعية والبيئية في المنطقة العربية» تحت إشراف منى خشن وسامي عطاالله.
From the same author
view allMore periodicals
view all-
12.19.25
المقالع تقضم الجبال: صناعة نظام اللاقانون
نزار صاغية, رين إبراهيمتضخّـم قطاع المقالع بعد عام 1990 بشكلٍ عشوائيّ، وتحوّل في معظمه إلى احتكارات تابعة لقوى نافذة تعمل خارج القانون. توثّـق هذه الورقة كيف تَشكّـل نظام اللاقانون في هذا القطاع، وما خلّفه من أضرار بيئيّة وماليّة واجتماعيّة، والدور الذي لعبته المواجهة القانونيّة–القضائيّة في إحداث أثر فعليّ على الأرض. ورقة بحثيّة من كتابة نزار صاغية ورين إبراهيم، ضمن مشروع “المناخ والأرض والحقّ” بالتعاون مع مبادرة سياسات الغد.
اقرأ -
11.21.25
وصفة لتبييض المسؤوليات في مجال الصرف الصحّي: الخلل في الصرف الصحي نظاميّ أيضًا
نزار صاغية, فادي إبراهيمتقدّم هذه الورقة خلاصةً دقيقة لتقرير ديوان المحاسبة الصادر في 27 شباط 2025 بشأن إدارة منظومة الصرف الصحّيّ في لبنان، مبيّنةً ما يعتريه من عموميّة وقصور، وما يكشفه ذلك من خللٍ بنيويّ في منظومة الرقابة والمحاسبة ومن الأسباب العميقة لتعثر محطّات معالجة الصرف الصحّي.
اقرأ -
04.24.25
اقتراح قانون إنشاء مناطق اقتصادية تكنولوجية: تكنولوجيا للبيع في جزر نيوليبرالية
المفكرة القانونية, مبادرة سياسات الغدتهدف هذه المسوّدة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، غير أنّ تصميمها يصبّ في مصلحة قلّة من المستثمرين العاملين ضمن جيوب مغلقة، يستفيدون من إعفاءات ضريبية وكلفة أجور ومنافع أدنى للعاملين. وبالنتيجة، تُنشئ هذه الصيغة مساراً ريعيّاً فاسداً يُلحق ضرراً بإيرادات الدولة وبحقوق الموظفين وبالتخطيط الإقليمي (تجزئة المناطق). والأسوأ أنّ واضعي السياسات لا يُبدون أيّ اهتمام بتقييم أداء هذه الشركات أو مراقبته للتحقّق من تحقيق الغاية المرجوّة من المنطقة الاقتصاديّة.
اقرأ -
02.05.25eng
أزمة لبنان بنيوية، لا وزارية
سامي زغيب, سامي عطاالله -
10.15.24eng
لا عدالة مناخية في خضمّ الحروب
منى خشن, سامي عطاالله -
06.14.24
عطاالله: التدّخل السياسي عقبة أمام تطوّر الإدارة العامة
سامي عطااللهمقابلة مع مدير مبادرة سياسات الغد الدكتور سامي عطاالله أكد أن "التدخل السياسي هو العقبة الرئيسية أمام تطور الإدارة العامة"، وشدد على أن دور الدولة ووجودها ضروريان جدًا لأن لا وجود للاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق من دونها"
اقرأ -
10.27.23eng
تضامناً مع العدالة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني
-
09.21.23
مشروع موازنة 2023: ضرائب تصيب الفقراء وتعفي الاثرياء
وسيم مكتبي, جورجيا داغر, سامي زغيب, سامي عطاالله -
09.09.23
بيان بشأن المادة 26 من مشروع قانون الموازنة العامة :2023
المادة ٢٦ من مشروع موازنات عام ٢٠١٣ التي اقرها مجلس الوزراء تشكل إعفاء لأصحاب الثروات الموجودة في الخارج من الضريبة النتيجة عن الأرباح والايرادات المتأتية منها تجاه الدولة اللبنانية. بينما يستمرون في الإقامة بشكل رسمي في لبنان ويتجنبون تكليفهم بالضرائب بالخارج بسبب هذه الإقامة. كما تضمنت المادة نفسها عفواً عاماً لهؤلاء من التهرب الضريبي. وكان مجلس الوزراء قد عمد إلى تعديل المادة 26 من المشروع ال مذكور، فيما كانت وزارة المالية تشددت على العكس من ذلك تماماً في تذكير بالمترتبات والنتائج القانونية والمالية الخطرة لأي تقاعس أو إخلال في تنفيذ الموجبات الضريبية ومنها الملاحقات الجزائية والحجز عىل الممتلكات و الاموال. واللافت أن هذا الإعفاء الذي يشمل ضرائب طائلة يأتي في الفترة التي الدولة هي بأمس الحاجة فيها إلى تأمين موارد تمكنها من إعادة سير مرافقها العامة ومواجهة الأزمة المالية والإقتصادية.
اقرأ -
08.24.23
من أجل تحقيق موحد ومركزي في ملف التدقيق الجنائي
في بيان مشترك مع المفكرة القانونية، مبادرة سياسات الغد، كلنا إرادة، وALDIC، نسلط الضوء على التقرير التمهيدي الذي أصدره Alvarez & Marsal حول ممارسات مصرف لبنان وأهميته كخطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية. ويكشف هذا التقرير عن غياب الحوكمة الرشيدة، وقضايا محاسبية، وخسائر كبيرة. إن المطلوب اليوم هو الضغط من أجل إجراء تدقيق جاد وموحد ومركزي ونشر التقرير رسمياً وبشكل كامل.
اقرأ -
07.27.23
المشكلة وقعت في التعثّر غير المنظّم تعليق دفع سندات اليوروبوندز كان صائباً 100%
-
05.17.23
حشيشة" ماكينزي للنهوض باقتصاد لبنان
-
01.12.23
وينن؟ أين اختفت شعارات المصارف؟
-
10.12.22eng
فساد في موازنة لبنان
سامي عطاالله, سامي زغيب -
06.08.22eng
تطويق الأراضي في أعقاب أزمات لبنان المتعددة
منى خشن -
05.11.22eng
هل للانتخابات في لبنان أهمية؟
كريستيانا باريرا -
05.06.22eng
الانتخابات النيابية: المنافسة تحجب المصالح المشتركة