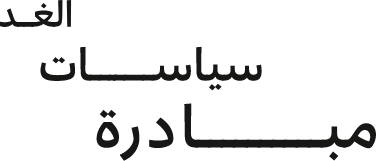- eng
-
- share
-
subscribe to our mailing listBy subscribing to our mailing list you will be kept in the know of all our projects, activities and resourcesThank you for subscribing to our mailing list.
إصلاح في الشكل لا في المضمون: قراءة في مسودّة موازنة لبنان لعام 2026

تأتي موازنة لبنان لعام 2026 في ظلّ عهد رئاسي وحكومة جديدين، وتقدّم بوصفها الاختبار الماليّ الأوّل لمرحلة سياسيّة تلت الحرب الإسرائيليّة على لبنان بين عامَي 2023 و2024 وما خلفته من دمار، وبعد ستّ سنوات من الانهيار الماليّ، والتخلّف عن سداد الديون السياديّة، وانفجار القطاع المصرفيّ الذي أعاد تعريف الأسس الاقتصاديّة للدولة. سياسيًّا، قدّمت الحكومة هذه الموازنة دليلًا على نيّتها الإصلاحيّة: فقد أُحيلت في موعدها إلى مجلس الوزراء، ضمن المهل الدستوريّة، وتُعرض على أنّها موازنة "متوازنة". وقد بلغت قيمتها 5.68 مليارات دولار، أي بزيادة نسبتها 14 في المئة عن عام 2025، مع تخصيصات أعلى للخدمات الاجتماعيّة، وتحسين الإنفاق على موظّفي القطاع العامّ ومختصاتهم الاجتماعيّة، وتخفيض الاحتياطيّات بنسبة 38 في المئة، وهي مؤشّرات توحي – في الظاهر – بانضباط ماليّ أفضل.
لكنّ ما يكمن خلف هذا الانتظام الإجرائيّ هو منطق ماليّ مألوف. فموازنة 2026 تقوم على البنية نفسها التي غذّت الأزمة المالية في السابق: نظام ضريبيّ رجعيّ يعتمد على الاستهلاك والأجور، بينما يحصّن رأس المال والأملاك؛ وهيكليّة إنفاق تهيمن عليها كلفة الأجور وتتحكّم فيها الاعتبارات السياسيّة. حتّى الإصلاحات المتعلّقة بالاحتياطيّات، وإن بدت إيجابيّةً في ظاهرها، تظلّ جزءًا من نمط أوسع من التعديلات المحاسبيّة، لا من إعادة ترتيب إستراتيجيّة للأولويّات.
وهذه الاستمراريّة ليست تقنيّة فحسب، بل هي سياسيّة في جوهرها. فالموازنة تكشف عن دولة تدير الندرة عبر الامتثال والاحتواء، لا عبر إعادة التوزيع والتجديد. كذلك، تظهر التباينات الكبيرة بين المسوّدات المتتالية للموازنة، من دون أن ترفق بتحوّلات في السياسات أو مبرّرات اقتصاديّة كلّيّة، ممّا يدلّ على "معايرة" أكثر ممّا يدلّ على "إصلاح". فهي متوازنة على الورق، لكنّها خاوية في المضمون، إذ تبقي على واجهة الدولة الإجرائيّة سليمةً، بينما تترك وظيفتها الاجتماعيّة والإنمائيّة معلّقةً من دون حسم. ولتحقيق الإصلاح الحقيقيّ، ينبغي للحكومة أن تواجه مجموعات المصالح السياسيّة والاقتصاديّة. غير أنّها، في هذه الموازنة، اختارت ألّا تقوم بذلك، وأن تبقي النظام على حاله تقريبًا.
تعافٍ رجعيّ: إيرادات متزايدة وأولويّات ثابتة
تتوقّع موازنة عام 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات – بنحو مليار دولار أكثر من العام السابق – غير أنّ نمط هذا الارتفاع يظهر استمراريّة أكبر ممّا يظهر تغييرًا. فمعظم الزيادة يأتي من الضرائب على الاستهلاك والأجور، في حين تبقى الجباية من الأرباح والأصول والمؤسّسات العامّة محدودة. وبهذا، تكرّس البنية الماليّة اختلالات مزمنةً في النظام الماليّ اللبنانيّ: قاعدةً ضيّقة، وضعفًا في التقدّميّة الضريبيّة، وعوائد محدودةً من أصول الدولة. وتدلّ هذه الاتّجاهات مجتمعةً على إطار إيرادات يسهم في استقرار الموازنة على المدى القصير، لكنّه يعجز عن استعادة العدالة أو المرونة الماليّة.
الإيرادات الضريبيّة: نموّ بلا تقدّميّة
من المتوقّع أن تبلغ الإيرادات 6.018 مليارات دولار، مدفوعةً أساسًا بزيادة قدرها 439 مليون دولار من ضريبة القيمة المضافة، و131 مليون دولار من الضرائب على الأجور والرواتب، و131 مليون دولار من الإيرادات غير الضريبيّة، و111 مليون دولار من رسوم العقارات والتسجيل، و92 مليون دولار من أرباح إدارات الاحتكار، و48 مليون دولار من الضرائب غير المباشرة. وعلى الورق، قد يبدو هذا التنوّع دليلًا على تعافٍ واسع النطاق، غير أنّه في الواقع يعبّر عن توسّع في القنوات القائمة ذاتها، لا عن نشوء مصادر جديدة وأكثر عدالةً للإيرادات.
أمّا داخل بنية ضرائب الدخل، فتوزيع النموّ يبدو غير متكافئ على نحو لافت. إذ يُتوقّع أن ترتفع الضرائب على الدخل بمقدار 163 مليون دولار، مدفوعةً تقريبًا كلّها بزيادة قدرها 131 مليون دولار في الضرائب على الرواتب (بنسبة 138 في المئة). وفي الظروف العاديّة، قد تشير هذه الزيادة الحادّة إلى نموّ اقتصاديّ قويّ ينعكس في ارتفاع الأجور، أو إلى تحسين في الجباية عبر تشديد التطبيق وتعزيز الامتثال. غير أنّ الموازنة لا تذكر أيّ تعديل في السياسات يمكن أن يبرّر هذه الزيادة. كما أنّ نسبة النموّ الاقتصاديّ المتوقّعة لعام 2026، بنحو 4 في المئة،1 لا تكفي لتفسير هذا الارتفاع الكبير في الضرائب على الأجور. فضلًا عن ذلك، فإنّ استمرار التفلّت من الطابع الرسميّ واتّساع فجوات الامتثال – النابعة من ضعف القدرة على التطبيق ومن الحوافز القويّة للتصريح الناقص، والتي تفاقمت بسبب بقاء التزامات نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ من دون حلّ – يبعدان أرجحيّة أن يكون ارتفاع إيرادات الضرائب على الأجور ناتجًا من تحسّن فعليّ في الامتثال.
وتظهر بقيّة بنية ضرائب الدخل الصورة نفسها من التقديرات غير المتكافئة والمشكوك فيها. إذ ترتفع الضرائب على الأرباح بنسبة طفيفة لا تتجاوز 12 في المئة (+39 مليون دولار)، في حين تنخفض الضرائب على الأصول المنقولة بنسبة 30 في المئة (–13 مليون دولار). وتقدّر هذه الأخيرة بنحو 14 في المئة فقط من قيمتها في عام 2018، ويفسّر ذلك جزئيًّا باستمرار هيمنة المعاملات النقديّة منذ الانهيار المصرفيّ، ممّا قلّل من قابليّة التتبّع وجعل الدخل الرأسماليّ أكثر صعوبةً في الجباية. غير أنّ التباين بين هاتَين الفئتَين يثير قلقًا أوسع: فلو كان الاقتصاد يتعافى حقًّا، لكانت ضرائب الأجور والأرباح والأصول قد تحرّكت في الاتّجاه نفسه، لا في اتِّجاهات متعاكسة.
وتؤكّد أرقام الحكومة الاختلال نفسه. فالارتفاع المتوقّع بنسبة 138 في المئة في إيرادات ضرائب الأجور سيرفعها إلى نحو 44 في المئة من مستواها عام 2018، مقابل 37 في المئة لضرائب الأرباح. وبما أنّ حجم الاقتصاد الكلِّيّ يبلغ اليوم نحو 36 في المئة من حجمه في 2018، فإنّ مسار ضرائب الأرباح يتوافق تقريبًا مع الانكماش الاقتصاديّ العامّ، بينما تتجاوز ضرائب الأجور هذا المستوى. وهذا يعني أنّ العاملين – ولا سيّما في الفئات الرسميّة ومتوسّطة الدخل – يسهمون بنسبة أعلى في التكيّف الماليّ مقارنةً بدخل الأعمال/الشركات ورأس المال. وعلى الرغم من أنّ الأرباح ما زالت تولّد مبالغ أكبر من حيث القيمة المطلقة، فإنّ وتيرة التعافي تحوّل العبء النسبيّ نحو العمل، من دون تحقيق تقدّم يذكر في العدالة أو في إعادة التوزيع.
وعلى نطاق أوسع، لا يزال الهيكل الضريبيّ ذا طابع رجعيّ واضح. ففي المصطلح الماليّ، يعني ذلك أنّ معظم الإيرادات يأتي من ضرائب تفرض بصورة موحّدة – مثال على ذلك ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركيّة، ورسوم التسجيل – بدلًا من أدوات تعاير بحسب الدخل أو الثروة. ولأنّ هذه الضرائب تستنزف نسبةً أكبر من مداخيل الفئات الدنيا والوسطى، فهي تثقل كاهل من هم أقلّ قدرةً على تحمّلها. وبينما يتوقّع أن ترتفع الضرائب غير المباشرة بمقدار 700 مليون دولار (أي بنسبة زيادة قدرها 20 في المئة، من 3.5 مليارات دولار إلى 4.2 مليارات دولار)، يفترض أن ترتفع الضرائب التصاعديّة على الدخل والأملاك بمقدار 133 مليون دولار (أي بنسبة 25 في المئة، من 526 مليون دولار إلى 659 مليون دولار). غير أنّ صغر قاعدة هذه الضرائب يجعل هذا النموّ الأسرع عديم الأثر تقريبًا في البنية العامّة: إذ ما زالت الضرائب التنازليّة تشكّل 86 في المئة من مجموع الإيرادات الضريبيّة، وهي النسبة نفسها لعام 2025. فالاستمراريّة لا تقتصر على الأرقام والنسب، بل تشمل التصميم ذاته، إذ لا تزال قواعد رئيسة خارج الشبكة الضريبيّة.
وفي هذا الإطار، تُذكر الأملاك البحريّة تحديدًا: فبينما تسجّل الموازنة نحو 35 مليون دولار من تسوية التعدّيات على الأملاك البحريّة العامّة، فإنّ هذه مبالغ تُجبى من مخالفات وتسويات لمرّة واحدة، لا من ضريبة دوريّة على الأملاك البحريّة. بمعنى آخر، حتّى وإن وجدت ضرائب على الأملاك في مواضع أخرى من النظام، تبقى الأملاك البحريّة فعليًّا خارج نطاق الضريبة، وهو ما يبقي اختبارًا أساسيًّا للعدالة والمصداقيّة من دون معالجة. فضلًا عن ذلك، لا تخضع الكسّارات والمقالع لأيّ ضرائب خاصّة بقطاعها، كما لا تفرض ضرائب انتقائيّة على السلع الفاخرة تتجاوز ضريبة القيمة المضافة القياسيّة.
أمّا الإيرادات الجمركيّة – وهي أحد الأعمدة التقليديّة لإيرادات الدولة – فلا تظهر تحسّنًا كبيرًا. فعلى الرغم من زيادة قدرها 62 مليون دولار عن عام 2025، تبقى المعدّلات الفعليّة منخفضةً (نحو 3 في المئة إذا كانت كمِّيّات الاستيراد مماثلةً لعام 2024)، ممّا يدلّ على استمرار التهرّب وضعف الجباية. فمع فاتورة استيراد تُقدَّر بنحو 15 مليار دولار، كان ينبغي أن تبلغ الإيرادات الجمركيّة نحو 1.5 مليار (أي 10 في المئة من الفاتورة)، مقارنةً بـ562 مليون دولار فقط، أي ثلث المستوى المفترض. ويظهر هذا النمط كيف أنّ مواطن الضعف المؤسّسيّة، لا الظروف الاقتصاديّة الكلّيّة، لا تزال تشكّل نتائج السياسة الماليّة.
وفي المحصّلة، لا تكشف هذه الديناميّات عن نظام ضريبيّ تنازليّ فحسب، بل غير فعّال أيضًا. فعبء التكيّف الماليّ ما يزال يقع على الاستهلاك والأجور، في حين تبقى الأدوات القادرة على إعادة توزيع الثروة أو الحصول على الريع الاقتصاديّ غير مطوَّرة أو غير مُطبَّقة. لم يتغيّر الاتّجاه إذًا: فعدم المساواة يُعاد إنتاجه عبر الوسائل الماليّة نفسها، حتّى مع نموّ الإيرادات الإجماليّة.
الإيرادات غير الضريبيّة: أصول عامّة غير مستثمرة كما ينبغي
خارج نطاق الضرائب، تبقى مصادر الإيرادات الخاصّة بالدولة ضعيفةً ومحدودة الاستخدام. فالمؤسّسات العامّة العاملة في قطاعات الاتّصالات والكهرباء والمرافئ والألعاب لا تنتج مجتمعةً سوى ما يزيد قليلًا على مليار دولار – أي ما يقارب 17 في المئة من مجموع الإيرادات – وهي نسبة أدنى بكثير من المتوسّط العالميّ البالغ نحو 35 في المئة. ويعكس هذا الفارق مشكلات بنيويّةً عميقة: نماذج عمل قديمة، واستقلاليّةً تشغيليّةً محدودة، ونظمًا محاسبيّةً غامضة، وتدخّلًا سياسيًّا يعطي الأولويّة للمحسوبيّة على حساب الأداء. والنتيجة قاعدة من الأصول العامّة لا تدرّ عائدًا ماليًّا يُذكر، وتسهم إسهامًا ضئيلًا في الإنتاجيّة الاقتصاديّة.
وبسبب عجز هذه المؤسّسات عن توليد دخل مستقرّ، يستمرّ التكيّف الماليّ في الاعتماد على الضرائب. وهذه التبعيّة تجعل الماليّة العامّة هشّةً وغير عادلة في آنٍ واحد: هشّةً لأنّ الإيرادات تتقلّب تبعًا لمستويات الاستهلاك والاستيراد، وغير عادلة لأنّ المزيج الضريبيّ يعتمد اعتمادًا كبيرًا على أدوات رجعيّة تثقل كاهل الفئات الدنيا والوسطى. وفي الوقت نفسه، تسهم هشاشة التتبّع الرقميّ، واتّساع الاقتصاد غير النظاميّ، وانتقائيّة التطبيق في استمرار مستويات مرتفعة من التهرّب الضريبيّ وتسرّب الإيرادات.
أولويّات الإنفاق: مكاسب تدريجيّة ضمن قيود بنيويّة
في جانب الإنفاق، تُظهر موازنة 2026 زيادات انتقائيّةً من دون مؤشّرات حقيقيّة على إعادة توجيه الأولويّات. فبعض القطاعات الاجتماعيّة والخدميّة شهد زيادات طفيفة، غير أنّ البنية العامّة للإنفاق بقيت شبه ثابتة. وقد ارتفعت مخصّصات الصحّة والتعليم والحماية الاجتماعيّة، لكن من دون إطار إصلاحيّ أو إعادة ترتيب شاملة للأولويّات، ممّا يجعل هذه الإضافات أقرب إلى تعديلات تعويضيّة أكثر منها إلى التزامات بنيويّة طويلة الأمد.
أولويّات الإنفاق: مكاسب اجتماعيّة محدودة ضمن بنية غير متغيّرة
تبلغ مخصّصات الخدمات الاجتماعيّة نحو 688 مليون دولار، أي ما يقارب 11 في المئة من إجماليّ الإنفاق. وتشمل أبرز الزيادات 31 مليون دولار للخدمات الصحِّيَّة المباشرة – بما في ذلك الاستشفاء والأدوية ودعم المستشفيات الحكوميّة – و21 مليون دولار لبرامج التعليم الرسميّ، و51 مليون دولار للحماية الاجتماعيّة ضمن وزارة الشؤون الاجتماعيّة. وتشير هذه التعديلات إلى محاولة للحفاظ على الوظائف الأساسيّة في ظلّ ضغوط ماليّة حادّة، غير أنّ حجمها يبقى محدودًا إذا ما قورِنَ بعمق الحاجات الاجتماعيّة وبالتآكل التراكميّ في جودة الخدمات منذ الأزمة. ومع ذلك، فإنّ هذه المكاسب المتواضعة تقوّض بفعل السياسات الضريبيّة الرجعيّة نفسها التي تضمّها الموازنة.
الإنفاق الاستثماري والأمنيّ: زيادات تدريجيّة من دون توجّه إستراتيجيّ
تنمّ النفقات الاستثماريّة (الرأسماليّة) عن طموح محدود مماثل؛ إذ ارتفع المجموع المخصّص له بمقدار 61 مليون دولار، ليبلغ 630 مليون دولار، من دون أيّ بند صريح مخصّص لإعادة الإعمار بعد الحرب. ويبدو ذلك لافتًا بالنظر إلى تقديرات الأضرار المادِّيّة التي تتجاوز 6.8 مليارات دولار، منها 4.6 مليارات دولار في قطاع الإسكان وحده (البنك الدوليّ، 2025).2 وبدلًا من إدراج الإنفاق على الإعمار بوصفه بندًا مستقلّ، جرى ضمّه إلى بنود رأسماليّة عامّة، فمن517 مليون دولار للمشاريع الجارية والصيانة، 25 مليون دولار مخصّصة لمجلس الجنوب (لا يخصّص منها للأعمال التحتيّة سوى 4.7 ملايين دولار)، ومبلغ رمزيّ قدره 225 ألف دولار للمجلس الأعلى للإغاثة لمعالجة أيّ اعتداءات إسرائيليّة مُحتمَلة. وتتناقض هذه الأرقام بوضوح مع الخطاب الرسميّ للحكومة الذي وضع الإعمار في صلب جدول أعمالها السياسيّ.
كما تبقى النفقات الأمنيّة موجّهةً إلى حدّ كبير نحو بند رواتب الموظّفين. فموازنة الجيش ترتفع من 808 ملايين دولار إلى 966 مليون دولار، غير أنّ هذه الزيادة تمتصّ بالكامل تقريبًا في الأجور والتعويضات، إذ لا يزيد الإنفاق الاستثماريّ سوى مليون دولار فقط. ويجسّد هذا النمط أحد القيود الماليّة الأوسع نطاقًا: ارتفاع النفقات الجارية لضمان الاستقرار المؤسّسيّ، مقابل ضعف الاستثمار في القدرات والتحديث.
رواتب الموظّفين والتعويضات: فاتورة أجور متنامية قائمة على عدم الاستقرار
تواصل كلفة الموظّفين هيمنتها على الموازنة، إذ تستحوذ على نحو 60 بالمئة من مجموع الإنفاق – أي ما يقارب 3.59 مليارات دولار في عام 2026 – وتشمل الرواتب والأجور والتعويضات والمساهمات والمزايا الاجتماعيّة. ظاهريًّا، يمثّل ذلك استمرارًا لنهج عام 2025، لكنّ تركيب الإنفاق يظهر ضغوطًا بنيويّةً أعمق. فضمن هذا الإطار، ترتفع كلفة الرواتب الإجماليّة – بما يشمل الأجور الأساسيّة والتعويضات والمساهمات – إلى نحو 1.49 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 405 ملايين دولار (نحو 37 في المئة) مقارنةً بالعام السابق. وتُعزى هذه الزيادة إلى التوسّع الكبير في التوظيف التعاقديّ وما يرتبط به من مساهمات من جانب صاحب العمل: إذ ترتفع رواتب المتعاقدين من 53 مليون دولار إلى نحو 196 مليون دولار، بينما تضيف مساهمات أصحاب العمل نحو 252 مليون دولار. في المقابل، تبقى رواتب الموظّفين الدائمين شبه ثابتة عند 331 مليون دولار. وقد يسهم هذا الاعتماد المتزايد على العمّال المتعاقدين في الحفاظ على الحدّ الأدنى من القدرة التشغيليّة للدولة على المدى القصير، غير أنّه يعمّق في الوقت نفسه اعتمادها على أشكال هشّة من العمل – ما يعرّض النظام لعمليّات توظيف خاضعة للوساطة السياسيّة، ويضعف استقرار الأجور، ويعقّد إمكانات التخطيط الطويل الأمد للقوى العاملة ضمن الكادر الدائم.
وما يثير القلق بالقدر نفسه هو الخلل بين الأجر الأساسيّ والتعويضات الإضافيّة. فمن مجموع ما خُصّص للرواتب، لا تتجاوز نسبة الأجر الأساسيّ 38 في المئة تقريبًا، في حين يتكوّن الباقي من بدلات ومساهمات. وقد أدرجت هذه التعويضات أساسًا بوصفها دعمًا مؤقّتًا لمواجهة التضخُّم، لكنّها باتت اليوم تتفوّق في قيمتها على الرواتب الدائمة نفسها. وعلى الرغم من أنّها تتيح دعمًا فوريًّا للدخل، فإنّ هيكلها يقلّص القاعدة القابلة للتقاعد ويضعف المنافع المستحقّة عند نهاية الخدمة، ممّا يهدّد في الوقت نفسه أمن العاملين واستدامة الماليّة العامّة. ومع مرور الوقت، فإنّ هذا الاعتماد على مداخيل غير قابلة للتقاعد ينطوي على خطر تكريس نظام تعويضات مُجزّأ وغير مستقرّ، يضعف المعنويّات والكفاءة داخل الإدارة العامّة.
المزايا الاجتماعيّة والمعاشات التقاعديّة: إغاثة انتقائيّة في ظلّ تفاقم اللاعدالة
ترتفع المزايا الاجتماعيّة من 1.32 مليار دولار في عام 2025 إلى 1.66 مليار دولار في عام 2026 – أي بزيادة تبلغ نحو 25 في المئة – غير أنّ هذا الرقم العامّ يخفي فجوات بنيويّةً عميقة. إذ ترتفع رواتب المتقاعدين بشكل حادّ من 281 مليون دولار إلى 846.9 مليون دولار، أي بنسبة 201 في المئة، في محاولة جزئيّة لاستعادة الحقوق التي تآكلت عبر سنوات الأزمة. ومع ذلك، يبقى هذا المجموع دون مستوى عام 2019 البالغ 1.9 مليار دولار، ولا يلبّي فعليًّا معايير الدخل التقاعديّ الكافي والعادل. فالزيادة تقدّم تخفيفًا قصير الأمد، لكنّها – إذ تعتمد أساسًا على بدلات مؤقّتة – تُظهر غياب إصلاح تقاعديّ منسجم ومستدام.
ويبرز تحدٍّ مُلِحّ آخر يكمن في المتقاعدين من القطاع الخاصّ، وهو لا يزال من دون معالجة. فقد ارتفعت التزامات نظام تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ بشكل حادّ بعد إعادة تقييم المخصّصات من سعر الصرف السابق (1,500 ل.ل.) إلى 89,500 ل.ل.، ممّا نقل العبء فعليًّا إلى أرباب العمل في القطاع الخاصّ، ممّا أدّى إلى انتشار التهرُّب من الإبلاغ عن الدخل وتقليص العمالة الرسميّة. وبما أنّ معظم احتياطيّات الصندوق كانت مستثمرةً في الدّين العامّ، فإنّ جزءًا من هذه الالتزامات ينبغي الاعتراف به بوصفه واجبًا على الدولة. ومع ذلك، لا تتضمّن موازنة 2026 أيّ مخصّص لهذا الغرض، ولا تقدّم أيّ دعم جديد للمتقاعدين خارج القطاع العامّ – مثل معاش أساسيّ شامل يمكن أن يتيح جميع كبار السنّ الحماية.
وفي هذا السياق، تفاقم الزيادات الانتقائيّة لمتقاعدي الخدمة العامّة، وغياب أيّ تدابير لمعالجة التزامات الضمان الاجتماعيّ أو لتأمين تغطية شاملة، التفاوت داخل منظومة الحماية الاجتماعيّة. وبينما تبقى المنافع المخصّصة للعاملين الفعليّين شبه ثابتة – باستثناء تغيّرات طفيفة في تعويضات العائلة وتعويضات المرض ومساهمات الصناديق التعاونيّة – يستمرّ الهيكل العامّ في تفضيل فئات محدودة من العمّال على حساب العدالة الاجتماعيّة الأوسع. وهكذا تكرّس الموازنة بنية رفاهٍ مجزّأة، تقدّم الإغاثة لفئة من الناس، لكنّها تترك مواطن الضعف البنيويّة من دون معالجة.
الاحتياطيّات والديون: انضباط أفضل، وغموض مستمرّ
يبدو الاتّجاه الأكثر تشجيعًا في معالجة بنود الاحتياطيّات ضمن الموازنة. فقد تراجعت حصّتها من إجماليّ الإنفاق من 13 في المئة عام 2025 إلى نحو 5 في المئة في عام 2026، في إشارة إلى انتقالٍ نحو قدرٍ أكبر من الانضباط والشفافية. وبلغ مجموع الاحتياطيّات الآن نحو 324 مليون دولار، منها 11 مليون دولار للأجور، و94 مليون دولار للضمانات الاجتماعيّة، و219 مليون دولار للنفقات الاستثنائيّة.
وعلى الرغم من أنّ هذه النسبة تبقى أعلى من النطاق المثاليّ المتعارَف عليه (بين 1 و3 بالمئة)، فإنّ هذا التراجع يضيّق مجال إعادة التخصيصات الاعتباطيّة، ويعزّز دور الرقابة البرلمانيّة. ويجسّد ذلك ابتعادًا تدريجيًّا عن الممارسات الماليّة الغامضة وغير الشفّافة التي كانت تعتمد سابقًا على احتياطيّات ضخمة غير مُصنَّفة بديلًا من التخطيط السياساتيّ، وهو ما يمثّل تحسُّنًا محدودًا، لكن ملموسًا، في حوكمة الماليّة العامّة.
على الرغم من هذه المكاسب الإجرائيّة، لا يزال ادّعاء الحكومة بوجود موازنة "بدون عجز" مضلّلًا. إذ تسجّل خدمة الدَين عند 291 مليون دولار، لكنّ هذا الرقم لا يشمل الالتزامات المتعلّقة بسندات الخزينة واليوروبوندات المعلّقة منذ تخلّف لبنان عن السداد عام 2020. وتبقى هذه الالتزامات قائمةً، وسوف تتطلّب في نهاية المطاف خطّة إعادة هيكلة شاملة لاستعادة المصداقيّة في الحسابات العامّة. ومن دون هذه الخطّة، فإنّ التوازن الظاهريّ المحقّق على الورق يخفي استمرار الدَين المستتر والمدفوعات المؤجَّلة.
فضلًا عن ذلك، يموّل جزء كبير من الإنفاق – ولا سيّما في مجالَي الدفاع وإعادة الإعمار – مباشرةً عبر شركاء خارجيّين، وبالتالي يستبعد من الإطار الماليّ الرسميّ. وهذه العمليّات الخارجة عن الموازنة تشوّه الحجم الحقيقيّ للإنفاق العامّ وتضعف شفافيّة العلاقة بين الدولة والجهات المانحة. ونتيجةً لذلك، تقدّم موازنة 2026 صورةً ماليّةً أضيق وأكثر تفاؤلًا ممّا يعكسه الواقع الفعليّ، إذ تحقّق أهداف التوازن الشكليّ من من دون معالجة مخاطر الملاءة الماليّة الأساسيّة.
مصداقيّة الموازنة: نظام إجرائيّ من دون إصلاح جوهريّ
تثير التعديلات الحادّة بين مسوّدة الموازنة المقدّمة إلى مجلس الوزراء وتلك المرسلة إلى مجلس النوّاب تساؤلات حول موثوقيّة البيانات الماليّة وشفافية عمليّة صنع القرار. فعلى صعيد الإيرادات، ارتفعت الضريبة على الأرباح من 133 مليون دولار في المسوّدة الأولى إلى 366 مليون دولار في الثانية – أي بزيادة قدرها 232 مليون دولار – كما ارتفعت الضريبة على الأصول المنقولة من 7 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار، أي بنسبة قدرها 316 في المئة. وتشير هذه القفزات المفاجئة، في ظلّ غياب أيّ إجراءات سياساتيّة جديدة أو افتراضات اقتصاديّة كلّيّة مختلفة، إلى إعادة "معايرة" أكثر ممّا تشير إلى تحسين في التقدير.
ويتبع جانب الإنفاق النمط نفسه. فقد انخفض الاحتياطيّ العامّ من 9.2 في المئة من إجماليّ الإنفاق في المسوّدة الأولى إلى 5.4 في المئة في الثانية، وأُعيد تخصيص الأموال المُحرَّرة أساسًا لتعويضات العاملين (+236 مليون دولار) ورواتب التقاعد (+213.5 مليون دولار). وقد حسّن هذا التعديل وضوح الموازنة عبر نقل الموارد من بند عامّ فضفاض إلى بنود محدّدة، ممّا قلّل من مجال إعادة التخصيص الغامضة والمتحكَّم فيها سياسيًّا.
ومع ذلك، يبلغ الفارق الإجماليّ بين المسوّدتَين نحو 860 مليون دولار – أي ما يعادل قرابة 15 في المئة من مجموع الإنفاق. وتشير تغيّرات بهذا الحجم خلال فترة قصيرة إلى ضعف الممارسات التقديريّة ومحدوديّة التنسيق في إعداد الموازنة. كما تقوّض هذه التقلّبات القدرة على التخطيط المتوسّط الأمد، وتعقّد آليّات التنفيذ، وتضعف ثقة الجمهور بنزاهة البيانات الماليّة ومصداقيّة عمليّة إعداد الموازنة.
الخلاصة: توازن إجرائيّ من دون تجديد ماليّ
من الناحية الشكليّة، تفي موازنة 2026 بالمعايير الإجرائيّة:: فقد أحيلت في موعدها، وتبدو متوازنةً اسميًّا، وتقلّص نسبة الاحتياطيّات. لكنّها مع ذلك تخفق في إحداث إعادة ضبط جوهريّة. فالنظام الضريبيّ ما زال تنازليًّا، وأصول الدولة لا تزال ضعيفة الأداء، ونفقات الأجور تقوم على البدلات بدلًا من الرواتب المستقرّة، ونفقات إعادة الإعمار رمزيّة، و«العجز الصفريّ» المُعلَن يستثني كلًّا من خدمة الدين المُعلَّقة والإنفاق المموَّل من الجهات المانحة خارج الموازنة. أمّا التقلّبات الحادّة بين المسوّدتَين الأولى والثانية فتقوّض أكثر الثقة في جودة البيانات وشفافية الإدارة الماليّة.
وسوف يتطلّب تصحيح المسار بشكلٍ موثوق قرارات مدروسةً وجريئةً. إذ ينبغي توسيع قاعدة الضرائب التصاعديّة مع حماية الاستهلاك الأساسيّ، وإصلاح بنية التوظيف والتعويضات في القطاع العامّ إصلاحًا بنيويًّا، ووضع خطّة متعدّدة السنوات لإعادة الإعمار تخضع للتدقيق وتستبدل المشاريع المجزّأة الحالية. كما يجب تحديد سقف لاستخدام الاحتياطيّات مع نشر تقارير شفّافة عنها، وإدراج العمليّات المموّلة من الجهات المانحة ضمن الموازنة، وربط ادّعاءات التوازن الماليّ بخريطة طريق واقعيّة لإعادة هيكلة الديون. وقبل كلّ شيء، ينبغي إعادة توجيه أولويّات الإنفاق نحو تحسينات ملموسة في قطاعات الصحّة والتعليم والحماية الاجتماعيّة – وهي المجالات التي يمكن للمواطنين أن يلمسوا فيها عمل الدولة فعليًّا.
خلاصة القول، لا تشكّل موازنة 2026 قطيعةً مع العادات الماليّة القديمة التي تبقي على الوضع القائم. فما لم تُقدِم الحكومة على مواجهة مصالح سياسيّة واقتصاديّة متجذّرة وإعادة تعريف غاية السياسة الماليّة، سوف يبقى لبنان عالقًا في نمطٍ من الانتظام الإجرائيّ الخالي من التقدُّم الحقيقيّ – يوازن حساباته بينما يعمّق أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية.
1. البنك الدولي. توقعات الفقر الكلي في لبنان: أبريل 2024 - ورقة بيانات (باللغة الإنجليزية). توقعات الفقر الكلي (MPO) واشنطن العاصمة: مجموعة البنك الدولي. http://documents.worldbank.org/curated/en/099159004082437157
2. البنك الدولي. لبنان - التقييم السريع للأضرار والاحتياجات (RDNA) (الإنجليزية). واشنطن العاصمة: مجموعة البنك الدولي. http://documents.worldbank.org/curated/en/099030125012526525
هذا المقال هو جزء من تعاون مبادرة سياسات الغد مع اليونيسيف في إطار مشروع مشترك بعنوان " سياسات من أجل مستقبل عادل"، بهدف تعزيز البحث المستقل والدعوة إلى تغيير السياسة العامة. يجدر بالذكر أن اليونيسيف لا تقر بوجهات النظر/التحليلات/الآراء التي يعبر عنها الكتّاب.
From the same author
view all-
02.05.25eng
أزمة لبنان بنيوية، لا وزارية
سامي زغيب, سامي عطاالله -
10.15.24eng
لا عدالة مناخية في خضمّ الحروب
منى خشن, سامي عطاالله -
06.14.24
عطاالله: التدّخل السياسي عقبة أمام تطوّر الإدارة العامة
سامي عطااللهمقابلة مع مدير مبادرة سياسات الغد الدكتور سامي عطاالله أكد أن "التدخل السياسي هو العقبة الرئيسية أمام تطور الإدارة العامة"، وشدد على أن دور الدولة ووجودها ضروريان جدًا لأن لا وجود للاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق من دونها"
اقرأ -
09.21.23
مشروع موازنة 2023: ضرائب تصيب الفقراء وتعفي الاثرياء
وسيم مكتبي, جورجيا داغر, سامي زغيب, سامي عطاالله -
10.12.22eng
فساد في موازنة لبنان
سامي عطاالله, سامي زغيب
More periodicals
view all-
11.21.25
وصفة لتبييض المسؤوليات في مجال الصرف الصحّي: الخلل في الصرف الصحي نظاميّ أيضًا
نزار صاغية, فادي إبراهيمتقدّم هذه الورقة خلاصةً دقيقة لتقرير ديوان المحاسبة الصادر في 27 شباط 2025 بشأن إدارة منظومة الصرف الصحّيّ في لبنان، مبيّنةً ما يعتريه من عموميّة وقصور، وما يكشفه ذلك من خللٍ بنيويّ في منظومة الرقابة والمحاسبة ومن الأسباب العميقة لتعثر محطّات معالجة الصرف الصحّي.
اقرأ -
04.24.25
اقتراح قانون إنشاء مناطق اقتصادية تكنولوجية: تكنولوجيا للبيع في جزر نيوليبرالية
المفكرة القانونية, مبادرة سياسات الغدتهدف هذه المسوّدة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، غير أنّ تصميمها يصبّ في مصلحة قلّة من المستثمرين العاملين ضمن جيوب مغلقة، يستفيدون من إعفاءات ضريبية وكلفة أجور ومنافع أدنى للعاملين. وبالنتيجة، تُنشئ هذه الصيغة مساراً ريعيّاً فاسداً يُلحق ضرراً بإيرادات الدولة وبحقوق الموظفين وبالتخطيط الإقليمي (تجزئة المناطق). والأسوأ أنّ واضعي السياسات لا يُبدون أيّ اهتمام بتقييم أداء هذه الشركات أو مراقبته للتحقّق من تحقيق الغاية المرجوّة من المنطقة الاقتصاديّة.
اقرأ -
02.05.25eng
أزمة لبنان بنيوية، لا وزارية
سامي زغيب, سامي عطاالله -
10.15.24eng
لا عدالة مناخية في خضمّ الحروب
منى خشن, سامي عطاالله -
06.14.24
عطاالله: التدّخل السياسي عقبة أمام تطوّر الإدارة العامة
سامي عطااللهمقابلة مع مدير مبادرة سياسات الغد الدكتور سامي عطاالله أكد أن "التدخل السياسي هو العقبة الرئيسية أمام تطور الإدارة العامة"، وشدد على أن دور الدولة ووجودها ضروريان جدًا لأن لا وجود للاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق من دونها"
اقرأ -
10.27.23eng
تضامناً مع العدالة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني
-
09.21.23
مشروع موازنة 2023: ضرائب تصيب الفقراء وتعفي الاثرياء
وسيم مكتبي, جورجيا داغر, سامي زغيب, سامي عطاالله -
09.09.23
بيان بشأن المادة 26 من مشروع قانون الموازنة العامة :2023
المادة ٢٦ من مشروع موازنات عام ٢٠١٣ التي اقرها مجلس الوزراء تشكل إعفاء لأصحاب الثروات الموجودة في الخارج من الضريبة النتيجة عن الأرباح والايرادات المتأتية منها تجاه الدولة اللبنانية. بينما يستمرون في الإقامة بشكل رسمي في لبنان ويتجنبون تكليفهم بالضرائب بالخارج بسبب هذه الإقامة. كما تضمنت المادة نفسها عفواً عاماً لهؤلاء من التهرب الضريبي. وكان مجلس الوزراء قد عمد إلى تعديل المادة 26 من المشروع ال مذكور، فيما كانت وزارة المالية تشددت على العكس من ذلك تماماً في تذكير بالمترتبات والنتائج القانونية والمالية الخطرة لأي تقاعس أو إخلال في تنفيذ الموجبات الضريبية ومنها الملاحقات الجزائية والحجز عىل الممتلكات و الاموال. واللافت أن هذا الإعفاء الذي يشمل ضرائب طائلة يأتي في الفترة التي الدولة هي بأمس الحاجة فيها إلى تأمين موارد تمكنها من إعادة سير مرافقها العامة ومواجهة الأزمة المالية والإقتصادية.
اقرأ -
08.24.23
من أجل تحقيق موحد ومركزي في ملف التدقيق الجنائي
في بيان مشترك مع المفكرة القانونية، مبادرة سياسات الغد، كلنا إرادة، وALDIC، نسلط الضوء على التقرير التمهيدي الذي أصدره Alvarez & Marsal حول ممارسات مصرف لبنان وأهميته كخطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية. ويكشف هذا التقرير عن غياب الحوكمة الرشيدة، وقضايا محاسبية، وخسائر كبيرة. إن المطلوب اليوم هو الضغط من أجل إجراء تدقيق جاد وموحد ومركزي ونشر التقرير رسمياً وبشكل كامل.
اقرأ -
07.27.23
المشكلة وقعت في التعثّر غير المنظّم تعليق دفع سندات اليوروبوندز كان صائباً 100%
-
05.17.23
حشيشة" ماكينزي للنهوض باقتصاد لبنان
-
01.12.23
وينن؟ أين اختفت شعارات المصارف؟
-
10.12.22eng
فساد في موازنة لبنان
سامي عطاالله, سامي زغيب -
06.08.22eng
تطويق الأراضي في أعقاب أزمات لبنان المتعددة
منى خشن -
05.11.22eng
هل للانتخابات في لبنان أهمية؟
كريستيانا باريرا -
05.06.22eng
الانتخابات النيابية: المنافسة تحجب المصالح المشتركة